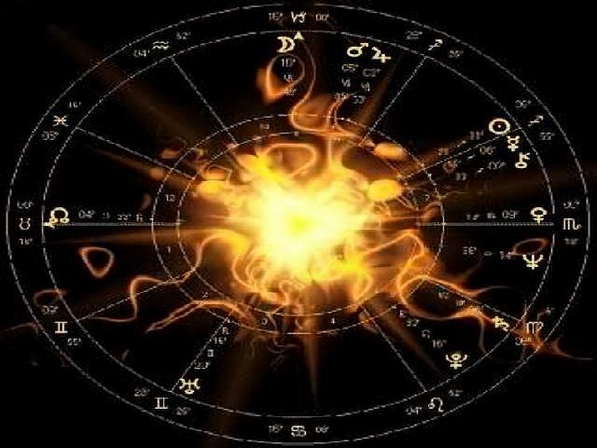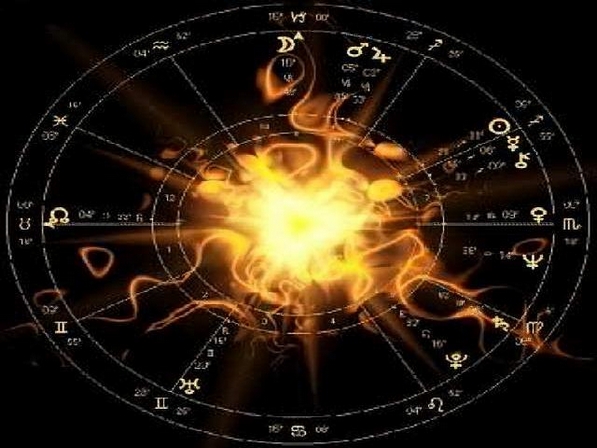لقد انكب الإنسان منذ أقدم العصور على دراسة السماء ومحتوياتها، تحرِّكه تلك القناعة الميتافيزيائية بأن للسماء سيطرة مطلقة على الأرض. إذ كان يؤمن أن الطبيعة واحدة وأن الطاقة التي تحرك كل ما فيها واحدة؛ وبالتالي، فكل حركة في هذا الكون لها تأثيرها وتبعاتها عليه وعلى محيطه.
لقد اشتملت دراسة الإنسان للفضاء الخارجي على وصف حركة النجوم وأبعادها من جهة ووصف تأثير هذه الحركة ونتائجها من جهة أخرى. أي أن التمييز الحقيقي بين علم الفلك وعلم التنجيم لم يكن موجوداً. واكتسبت دراسة علم الفلك أهمية بالغة لأنها ترتبط بمختلف علوم الطبيعة، وذلك بسبب تأثير الأفلاك على جميع ما يحدث في “عالم ما دون القمر”.
ولم يكن يُنظَر إلى هذا العلم على أنه شكل إنساني صرف من أشكال المعرفة، بل هو علم أوحِي به إلى النبي إدريس أو هرمس المثلث بالحِكَم الذي صعد إلى زحل لاستحضار علم النجوم إلى الأرض. فدراسة الأفلاك، إذن، ذات طبيعة مقدسة ولها جانب من الحقيقة المُنزَلة.
ولكن الفصل بين علمي الفلك والتنجيم تكرس في القرون الوسطى انسجاماً مع سيرورة العلم ككل، أي محاولة الفصل بين العلوم الميتافيزيائية والعلوم الموضوعية.
إن معرفة الكون في علم التنجيم مدخل لمعرفة النفس الإنسانية وربط النفس ومعرفتها بالتحولات الكونية، محاولةً لإخراج عالم النفس المجهول إلى دائرة الضوء وتسهيل تصنيف النفس ودراستها تبعاً لأنماط محددة. وهذا الارتباط كان يستند إلى فكرة حدسية تشبِّه العالم بالإنسان الكبير أو تشبه الإنسان بكون صغير.
ونأخذ من إخوان الصفا (الذين كانوا من علماء آل البيت عليهم السلام) ما جاء في مقدمة إحدى رسائلهم:
“إن معنى قول الحكماء “العالم”، إنما يعنون السموات السبع والأرضين، وما بينهما من الخلائق أجمعين. وسمُّوه أيضاً إنساناً كبيراً لأنهم يرون أنه جسم واحد بجميع أفلاكه وأطباق سمواته وأركان أمهاته ومولداته. ويرون أيضاً أن له نفساً واحدة سارية قواها في جميع أجزاء جسمها كسريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده…” ويتابعون: “نريد أن نذكر في هذه الرسالة صورة العالم ونَصِف كيفية تركيب جسمه كما وُصِف في كتاب التشريح تركيبُ جسد الإنسان. ثم نصف في رسالة أخرى ماهية نفس العالم، وكيفية سريان قواها في الأجسام التي في العالم، من أعلى الفلك إلى منتهى مركز الأرض.”
ولكن القول بتماثل وارتباط العالم الأرضي بالعالم العلوي لا يعني أبداً إمكانية التنبؤ بمصير كل ما يتحرك في هذا العالم، كما حاول بعضهم أن يصور أن علم النجوم لا يدَّعي ولا يحقُّ له أن يدَّعي إمكانية التنبؤ بالأحداث. يقول إخوان الصفا عن هذا الأمر: “إن كثيراً من الناس يظنون أن علم أحكام النجوم هو ادعاء الغيب. وليس الأمر كما ظنوا لأن علم الغيب هو أن يعلم ما يكون بلا استدلال ولا علل ولا سبب من الأسباب وهذا لا يعلمه أحد من الخلق.” كما أن ابن سينا ينتقد المنجمين بسبب ادعائهم القدرة على التنبؤ بالأحداث بشكل دقيق، ولكنه لا ينفي وجود تأثيرات فلكية في عالم المتغيرات، ويؤمن بأهمية تلك التأثيرات على الأحداث التي تجري على الأرض.
وقد أجبرت الوقائع العلمية المثبَتة العلماء على العودة إلى هذه الفكرة. إذ يقول الطبيب كلود برنار في كتابه مدخل لدراسة الطب التجريبي: “لا يشكل الكائن الحي استثناء من التناغم الطبيعي الكبير الذي يجعل الأشياء تتكيف بعضها مع بعض. فهو لا يكسر أي توافق وهو لا يتناقض ولا يتواجه مع القوى الكونية عموماً، بل على العكس يساهم في السيمفونية الكونية للأشياء وليست حياته إلا جزءاً من الحياة الكلية في الكون.”
ولا يخفى اليوم على أحد أهمية أشعة الشمس للحياة بكل أشكالها على الأرض. بل إن باستور يقول إن جميع أشكال الحياة هي في بنيتها وشكلها واستعداداتها وأنسجتها على علاقة صميمية بحركة الكون.
وإضافة إلى ما لتتابع الليل والنهار وتتابع الفصول وأطوار القمر من تأثير على حياة الإنسان، فإن التقنيات العلمية الحديثة سمحت باكتشاف تأثيرات كونية عديدة أخرى. ولها تأثيرها أيضاً، كما تدل الدراسات الحديثة، على النفس الإنسانية والسلوك الإنساني. أي أن الأهمية التي كان يعزوها المنجمون لحالة السماء وقت الولادة لا يمكن إنكارها، وهي طريقة اعتمدت للتعرف إلى الأفراد والاستدلال على عالمهم الداخلي.
لقد أثبتت الفيزياء أن الطبيعة لا تعرف أي تحوُّل مجاني. فأي أمر يحدث في الطبيعة له دور يؤديه في سمفونية القوى الطبيعية الكونية. ويوجد الإنسان في قلب هذا الكون مثلما يوجد الكون في داخله، وهو ليس في منأى عن التحولات الكونية، وهو يتفاعل معها بطريقته. فهناك حوار نفساني وبيولوجي ثابت منذ البدء بين الحياة وذاك المحيط البعيد المتشكل من الشمس والقمر والكواكب